كساء الكلمة الإلهية وجوهرها – المطران سابا (اسبر)
عطفاً على ما كتبته الاثنين الفائت حول الوحي الإلهي، وأسلوب إيصاله إلى البشر، وأهميّة البعد الثقافي الذي يحمله، ويعود إلى زمن كتابته، أتابع التوضيح ابتداء بمَثَل الزارع، الذي ضربه المسيح، ومن ثمّ عاد ففسّره. وقد ورد في العهد الجديد في كلّ من إنجيل متّى(13) ومرقس(4) ولوقا(8).
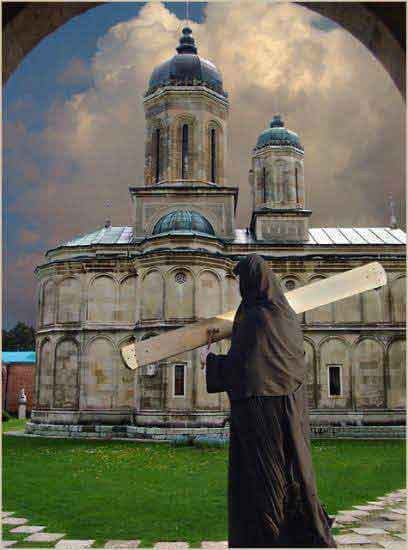 يدور المَثَل حول حبّات الحنطة التي تقع على أنواع مختلفة من الأرض، في أثناء إتمام عمليّة زرعها. يفهم سكّان بلادنا، في الشرق،المَثَل بسهولة، ولا يطرحون السؤال حول كيفيّة سقوط بعض الحَبّ هنا أو هناك: بعضه على أرض صخرية وبعضه بين الشوك وبعضه على الطريق. ذلك لأنّ الزراعة في بلادنا لا تزال تتمّ بالطريقة ذاتها التي كانت تتمّ فيها في فلسطين منذ ألفي عام. يخرج الزارع إلى أرضه المفلوحة، مزنِّراً خصره بجيبٍ كبير مملوء بالقمح ويسير في الأرض المراد زراعتها وهو يملأ قبضة يده بحبّات الحنطة، وينثرها على المدى الذي تصل يده إليه. فإنْ وُجدت بقعة شوكيّة فقد تنزل بعض الحبّات فيها، وكذلك على الطريق القادومية التي تفصل بين أرضه وأرض جاره.
يدور المَثَل حول حبّات الحنطة التي تقع على أنواع مختلفة من الأرض، في أثناء إتمام عمليّة زرعها. يفهم سكّان بلادنا، في الشرق،المَثَل بسهولة، ولا يطرحون السؤال حول كيفيّة سقوط بعض الحَبّ هنا أو هناك: بعضه على أرض صخرية وبعضه بين الشوك وبعضه على الطريق. ذلك لأنّ الزراعة في بلادنا لا تزال تتمّ بالطريقة ذاتها التي كانت تتمّ فيها في فلسطين منذ ألفي عام. يخرج الزارع إلى أرضه المفلوحة، مزنِّراً خصره بجيبٍ كبير مملوء بالقمح ويسير في الأرض المراد زراعتها وهو يملأ قبضة يده بحبّات الحنطة، وينثرها على المدى الذي تصل يده إليه. فإنْ وُجدت بقعة شوكيّة فقد تنزل بعض الحبّات فيها، وكذلك على الطريق القادومية التي تفصل بين أرضه وأرض جاره.
أمّا في الغرب فيحتاج الناس إلى معرفة طريقة زراعة القمح في فلسطين في القرن الأوّل الميلادي، كي يبدأوا بتفسير المَثَل. ذلك لأنّ الزراعة في الغرب تتمّ ميكانيكيّاً، بواسطة آلات وتقنيات تختلف كثيراً عن طريقة الزراعة في تلك الأيام.
هذا ما نسمّيه بالثقافة المرتبطة بالزمن. فالكتاب المقدّس، ككلّ كتاب، يحمل ثقافة الزمن الذي كًتب فيه. وبمقدار ما تكون المسافة الزمنية كبيرة بين المؤمنين وبين زمن الكتابة، تكون الحاجة ماسّة أكثر إلى شرح وتوضيح البعد الثقافي الذي يحمل الكلمة الإلهيّة، بغية الوصول إلى جوهرها، وتالياً عيشها.
ضرب الرب هذا المَثَل ثم فسّره لأنّ معناه لا ظاهره، هو الهدف. فقال الزارع هو الله، والزرع هو الكلمة الإلهيّة، والأنواع المختلفة من الأرض التي سقط الحَبّ عليها، أنواع مختلفة من نفوس البشر، التي تستقبل الكلمة الإلهيّة. قصّة الزارع، إذاً، مجرّد أداة لإيصال التعليم الإلهي إلينا. لماذا اختار الربّ التكلّم بالأمثال، ولم يطرح تعليمه مباشرة؟ لأنّ البشر يحفظون القصّة سريعاً ويفهمون مغزاها، بينما،على العكس من ذلك، فالتعليم المباشر، يُنسى بسهولة. إلى ذلك يبقى إسقاط التعليم بالمَثَل أو بالقصّة، على حياة السامعين، في أيّ عصر وُجدوا فيه، ممكناً بمرونةٍ تتجاوز الشكل الظاهري للقصّة، لتلاقي مضمونها ورسالتها.
يقول الربّ إنّ الحَبّات التي وقعت بين الأشواك واختنقت، تمثِّل الكلمة الإلهيّة التي تقع في نفوس المنشغلين بهموم هذه الدنيا، التي تخنق الكلمة الإلهيّة ولا تسمح لها بالنمو. ولكن ما هي هذه الهموم المعيشية؟ عموماً هي كلّ اهتمام يطغى على محبّة الله ويعيق الإنسان عن العيش بحسب وصاياه الإنجيليّة. ولكن،إن أردنا أن نعيش هذه الكلمات، الآن وهنا، علينا معرفة همومنا نحن، التي تختلف عن هموم من عاشوا قبلنا، الذين كان زمنهم مختلفاً. معرفتنا بهمومنا الخانقة لكلمة الربّ تعطينا معرفة كيفيّة محاربتها والتصدّي لها، وتالياً البدء بعيش الإنجيل.
فضغط الحاجات المعيشيّة الذي نحياه اليوم، على سبيل المثال، لم يكن يستهلك طاقة الإنسان العصبيّة والنفسيّة منذ أربعين سنة خلت في بلادنا، كما هو حالياً، بالرغم من أن الفقر كان أقسى بكثير من الآن.
هكذا وصلتنا الكلمة الإلهية معجونة ومجبولة بحياة الرسل والأنبياء الذين دوَّنوها وحفظوها لنا. ولذلك يدرس طلاب اللاهوت ثقافات الشرق الأوسط القديمة. تساعدهم هذه الدراسة على فهم كثير من الأحداث الواردة في الكتاب المقدَّس.
عندما نقرأ في الإنجيل أن بعض الرجال نقبوا السقف لكي ينزلوا المُقعد منه ليمْثُل أمام يسوع، لم يكن جيلنا يتساءل باستغراب: كيف يُنقب السقف. لأنّنا كنّا نرى في زياراتنا للقرى كثيراً من البيوت التي سقفها مصنوع من اللبن والقش، والتي كانت تحتاج إلى صيانة في كلّ صيف. أمّا جيل اليوم فيحتاج إلى تصوّر هذه البيوت حتّى يصدّق أنّ سقفاً يمكن أن يُنقب بسهولة، وإلا فإنّه سيعتبر الإنجيل كتاباً لا مصداقيّة فيه، كما يعتبر كثيرون اليوم العهدَ القديم. كيف لمن ولد وعاش في بيئة الإسمنت المسلّح أن يصدّق سهولة صنع فتحة في السقف؟ تحتاج إلى أن تشرح له طريقة بناء البيوت في الشرق القديم!
اعتاد الأنبياء في العهد القديم أن يقوموا بتصرّفات غريبة. فدانيال النبي، على سبيل المثال لا الحصر، كان يشرب الماء وهو يرتجف، في الفترة التي سبقت سقوط مدينة القدس بيد البابليين. كان هذا أسلوباً عنده للقول بالهول القادم على المدينة. كذلك لم يقم بمراسم الحداد على امرأته عندما ماتت، لكي يلقي عبرة للجميع مفادها،أنّ موت زوجته ليس بشيء مقارنةً بالمأساة الرهيبة القادمة. بالطبع قال هذا وشرحه وأسمعه للناس، ولكن عدم حداده على زوجته كان أسلوباً غير مألوف، جعل نبوءته تصل بسرعة إلى الناس، وتتثبّت في ذهنهم، لأنّ الصورة لا تُنسى بسهولة كما الكلام المباشر.
الروح التي نتعاطى بحسبها مع الكتاب المقدس هي الأساس والأهمّ. إن كنت تعتبره رسالة الله لك، فأنت تُقبل إليه بفرح وتواضع، واضعاً ذاتك في حالة طلب لمعرفة مشيئة الله فيه. أمّا إذا أقبلت إليه بعقل “منتفخ” ومواقف مسبقة ونقد لا يحترم ثقافة زمانه، فلن تدخل إلى جوهره، ولن تتخلّلك كلمة الله المخبوءة فيه.
فتح جَدّان صندوق ذكرياتهما أمام حفيدهما، وذلك بعد الاحتفال بعيد زواجهما الخمسيني. وأخرجا منه، بكثير من العناية والاحترام والفرح، ورقةً صفراء قديمة، وقبَّلاها قبل أن يرياه إيّاها. اندهش الحفيد عندما قرأ المكتوب في هذه الورقة. كانت حلاً لمسألة رياضيات. لكن الجدّين شرحا له قيمتها بالنسبة لهما. لقد كانت بالنسبة لهما أوَّل رسالة غرام تبادلاها. عندما عرف الجد أنّ من يحبّها، ويتحيّن فرصةً للحديث معها، بحاجةٍ إلى حلّ إحدى مسائل الرياضّيات، كتبها لها وأهداها إيّاها. بعد خمسين سنة، مازال المكتوب على الورقة مسألة حسابيّة، لكنهما كانا يريان فيه ما يتجاوزها، انطلاقاً منها إلى الأهم!
+القضية قضية حبّ ووَلَه، أو نبقى على جفاف العقل، فيقتلنا العطش.
