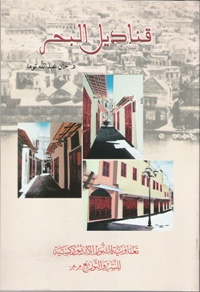 مائة وعشرون صفحة من القطع الصغير نقلتني إلى السنوات الغوابر من عمر الميناء، ورمتني في طرق هذا الثغر وأزقّته، مارًا أمام الأقبية والكنائس والمساجد والمدارس والحوانيت والمقاهي والمراكب والموانىء. وفي هذا المشوار التاريخي اصطحبت هذا وذاك من شخصياتها الّذين يصرّح الكاتب أنّ “لا علاقة لها بالواقع” . والميناء هنا، وإن كانت مقصودة بالذات عند راوي “قناديل البحر”، إلاّ أنّها عندي أنا القارىء أنموذج مدن هذا المشرق، والأشخاص الّذين أحيتهم الحكاية يشبهون العديد من الآباء والأجداد الّذين عاشوا وتحرّكوا بين المحيط والخليج.
مائة وعشرون صفحة من القطع الصغير نقلتني إلى السنوات الغوابر من عمر الميناء، ورمتني في طرق هذا الثغر وأزقّته، مارًا أمام الأقبية والكنائس والمساجد والمدارس والحوانيت والمقاهي والمراكب والموانىء. وفي هذا المشوار التاريخي اصطحبت هذا وذاك من شخصياتها الّذين يصرّح الكاتب أنّ “لا علاقة لها بالواقع” . والميناء هنا، وإن كانت مقصودة بالذات عند راوي “قناديل البحر”، إلاّ أنّها عندي أنا القارىء أنموذج مدن هذا المشرق، والأشخاص الّذين أحيتهم الحكاية يشبهون العديد من الآباء والأجداد الّذين عاشوا وتحرّكوا بين المحيط والخليج.
ولـمّا انتهيت من قراءة الرّواية، وأغلقت دفّتيها، حضرني السؤال التّالي: لماذا يعود دومًا جان توما إلى الماضي من الأيّام يستدنيه ويستنطقه؟ لماذا يرتاح إلى حكايات الآباء؟ لماذا يأمن مترنّحًا إلى الروايات الشعبيّة والذكريات، يستحضرها وينثرها حبرًا على ورق؟ .
بين الماضي الملجأ والأمل الباقي
وفيما أتأمّل في هذه التساؤلات، لعلّي أجد لها تفسيرًا شافيًّا،لم أهتد إلاّ إلى إفلاس الحاضر سببًا لإحياء الماضي وحكاياته. ماتت اليوم القضيّة والقضايا، وأضحى السواد الأعظم من الشباب غير مسيّسين، لا بل يكروهون السياسة ورجالاتها، وإذا تحمّسوا فإنّـما حماسهم لشخص لا لمبادىء، وإذا قرؤوا صحيفة فهم يكتفون بالخبر والتعليق ويُعرضون عن المقال والتحليل، شُلّ الفكر فتعطّلت الحريّة وسادت القوّة. من أجل كلّ ذلك يميل النّاس، بشكل طبيعيّ، إلى استذكار ومضات الماضي لـمّا تعميهم عتمات الحاضر الدّامسة، ويفتشون عن فيء عتيق يستظلّونه في هجير اليوم الحارق، ويشتاقون إلى المقاهي تقرأ فيها افتتاحيات الصحف، ويصغي إليها القادرون على القراءة والأميون، ويجري النقاش حولها ويحتدم. فما سعيُ توما في كتاباته إلى إحياء الماضي تصرّفًا غريبًا، ولكنّه موقف طبيعيًّ عبّر عنه البحتري لما أنشد مشتاقًا إلى عهد كسرى ملك الفرس بعد الصحراء الّتي ذاقها إثر مقتل المتوكّل الّذي معه ولّ الزمن الفارسي، يومها قال : “ذكّرتنيهم الخطوب التّوالي…” جان توما لم يُطق فراغ اليوم وإفلاسه فاستذكر الأيام الخوالي وحياتها وحلاوتها، لم يؤمّنْ له الحاضرُ المشتهى فلجأ إلى الماضي وحِضْنَه ليَبُلَّ الحَلْق وينعم بدفء النّضال. جان توما، كما بطله نجيب، قفز من واقع المرارة إلى حلاوة الذكرى. تذكر نجيب نعومة خدّ الحبيبة لـمّا جرّحه زجاج السور المؤدي إلى البحر، وتذكّر عهد النّضال لـمّا لمح الدّم المهراق من الكفّ .
وبالرغم من كلّ هذا السواد يبقى للأمل فتيل، وبالرغم من موت الأحلام واختناق الهواجس يبقى، عند أبناء الرّجاء، أن الحياة أقوى من الموت و”أنّ الأمل لن يمضي، وأن قدر هذه البلاد أن تستيقظ يومًا، وأن شعوبها لن تنحني أمام المصاعب والمؤامرات.”
هكذا مَن يعيشُ الخيبة يلجأ ليطمئنّ إلى شاطئين اثنين: تارة يرسي سفينته على شط النسيان فيألف الماضي، وتارة أخرى يقوده الأمل الباقي إلى أفق المستقبل فيطرد الذكريات ويرمق الأفق الآتي ولسان حاله يردّد مع شاعر ما زال صوته يتردد في هذا الصرح الّذي يضمّنا وهو المرحوم حسيب غالب:
يا ذكريات الأمس ذهني غادري فأنا أعيش بمقبلي وبحاضري
“قناديل البحر” ملأى بالحوارات مع الذّات في ماضيها وتطلعاتها. الخيبة حملت “نجيبًا” إلى غصّة الرحيل ولكنها لم تفقده الأمل في أن يتناهى الليل وينبلج النّهار، نهار الوحدة والحرّيّة و”أن تنجب الأمّة من يجدد عزّها” . “فلم تَسقط الأحلام من سلّة نجيب بل بقيت تتورّد وتزهر وكأنّ العمر شرفة بيت ربيعي، أكلّما أسقطت وردة أوراقها على الأرض انتعشت التربة وصارت إلى بهاء؟!”
محطّات مشرقة معزّية
وفيما نمخر عباب هذه الرّواية نجد أنفسنا إزاء القضايا الضائعة التي كلّفت الكثير من النضّال والسهر والسجون والتي تجسّدت في “نجيب” الّذي يصوّره المؤلّف رمزًا لإنسان هذه البيئة الوطنيّة النّاهدة إلى الوحدة والحريّة والعدالة والمساواة.
والذكريات الحلوة الّتي يستحضرها نجيب الهارب تبيّن كيف أن “العقل كان سيّد الموقف” وكيف أن الإنسان ذا القدر البسيط من التحصيل العلميّ كان مستعدّا لتقبّل الفِكَر ومناقشتها وقبول ما يروق له منها، إنها الحريّة المعيوشة الصّادقة وبدون مثلها الحريّة جعجعة كلام لا تكلّف شيئًا.
ويذكّرنا الكاتب بماض اقتصادي نفتقده اليوم لألف سبب وسبب: يقول”وشهد تحميل الحامض الطرابلسي في المراكب المتوجهة إلى مصر…” فهل نعرف اليوم انتاجًا نصدّره إلى الخارج؟ هل ما بقي عندنا بساتين ليمون يتضوع منها العطر وتجني الذّهب؟
