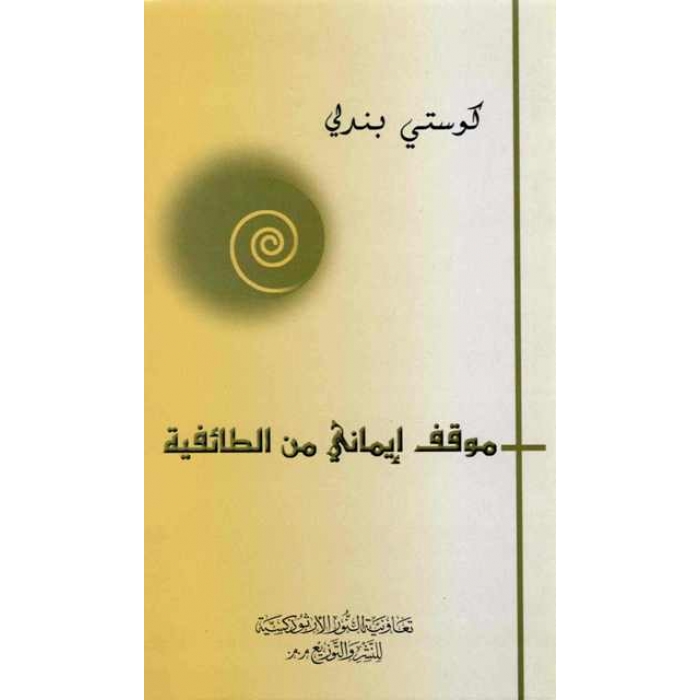 ما يضفي أهمية على صدور الطبعة الثانية من كتاب “موقف إيماني من الطائفية” للدكتور كوستي بندلي هو أنها تأتي في زمن يعود فيه الاصطفاف الطائفي، بزخم، ليحدّ من الحالة الوحدوية الاستثنائية التي كادت أن تبطل مبرّراته. فقدَر اللبنانيين أن يولدوا من رحم الصدمات. وهم عادوا ليدركوا، بعدما أملوا الكثير من مظاهر الوحدة التي تلت حدث الاغتيال الكبير في 14 شباط، أن تلك المظاهر إنما كانت وليدة انفعال آني لا وليدة قناعة وتوجّه. ولا أجد أدلاًّ على ذلك من محتوى النقاش السياسي الذي ساد مؤخّراً وهويّة قانون الانتخاب الذي تتوجّه الطبقة السياسية إليه. ودون أن يُعرضَ المرء عما حملته هذه المرحلة من ايجابيات فأن كثافة التغنّي “بالوحدة الوطنية” التي تجلّت في ساحات الوطن لم تقنع أحداً بإمكان استمرار هذا الإنجاز “الوحدوي” ما لم يسارع الشباب المعني إلى تحصين ذاته بما يملأ الفراغ الذي سينتج عن زوال حال الانفعال فيها.
ما يضفي أهمية على صدور الطبعة الثانية من كتاب “موقف إيماني من الطائفية” للدكتور كوستي بندلي هو أنها تأتي في زمن يعود فيه الاصطفاف الطائفي، بزخم، ليحدّ من الحالة الوحدوية الاستثنائية التي كادت أن تبطل مبرّراته. فقدَر اللبنانيين أن يولدوا من رحم الصدمات. وهم عادوا ليدركوا، بعدما أملوا الكثير من مظاهر الوحدة التي تلت حدث الاغتيال الكبير في 14 شباط، أن تلك المظاهر إنما كانت وليدة انفعال آني لا وليدة قناعة وتوجّه. ولا أجد أدلاًّ على ذلك من محتوى النقاش السياسي الذي ساد مؤخّراً وهويّة قانون الانتخاب الذي تتوجّه الطبقة السياسية إليه. ودون أن يُعرضَ المرء عما حملته هذه المرحلة من ايجابيات فأن كثافة التغنّي “بالوحدة الوطنية” التي تجلّت في ساحات الوطن لم تقنع أحداً بإمكان استمرار هذا الإنجاز “الوحدوي” ما لم يسارع الشباب المعني إلى تحصين ذاته بما يملأ الفراغ الذي سينتج عن زوال حال الانفعال فيها.
لا أشكّ بأن من سبل هذا التحصين أن يمتلك شبابنا قناعة كيانية صادقة باللاطائفية كتلك التي يرسم معالمها الدكتور كوستي بندلي في كتابه. فالكتاب يوسَم بأكثر من خصوصية منها هويّة كاتبه الإيمانية وارتكازه إلى الفكر الإيماني المسيحي لإبراز حجم التناقض القائم بين التديّن والتطيّف. فبندلي، المختصّ بالفلسفة وعلم النفس، هو مؤمن ممارس يصنّفه الوسط الكنسي الأرثوذكسي كأحد أبرز مفكريه في عصرنا الحالي، وذلك لتعدّد كتاباته التي قاربت، بفكر إيماني منفتح، وجوها متعدّدة منها علاقة الله بالكون وشؤون التربية والعدالة واللاعنف إضافة إلى مواضيع تهمّ الشباب والمجتمع.
غير أن هذه الهويّة الإيمانية لم تحصر خطاب الكاتب بالمسيحيين. بل هي ما أضفى على توجّهه للمسلمين، الذي أشارت إليه مقدّمة الدكتور أسعد قطان، صدقية تستشعر معها أن هذه الخطوة تخرج عن الأشكال “الفولكلورية التعايشية الملزمة” التي اعتادها القارئ مع كثير من المتعاطين بشؤون الثقافة والفكر. فهي ترجمة لقناعة بندلي الإيمانية باللاطائفية التي دفعته إلى أن يستجلي “إمكان مقاربة مشتركة للمعضلة الطائفية”. وقد شاء الكاتب أن يفتتح هذا التوجّه بإهداء الكتاب إلى صديق له من أئمة المسلمين في طرابلس، المدينة الإسلامية الهوى والتراث، التي نشأ فيها بندلي والتي تشهد على ما غرسه في نفوس أبنائها من جمال لاطائفي عبر التعليم والنشر والمواقف إزاء العديد من القضايا الوطنية، خاصة ازاء الحرب اللبنانية وتداعياتها.
ما يطمح إليه المؤلّف من كتابه هو أن يمتلك الشباب اللبناني هذه القناعة الإيمانية باللاطائفية فيتحرّر من الأشكال الفولكلورية. ذلك لإيمانه بأن خلاص الطوائف من عصبياتها القتالة ينبع من عودتها إلى أصالة الإيمان الذي يجعلها تنتصب أمام الله فقيرة عارية. وهو لم يستند ، في سعيه هذا، الى موقف ايماني مجرّد من الابعاد الفكرية والسياسية، ما دفعه إلى أن يطرح إمكان اختلاف غيره من المسيحيين معه في موقفه الرافض للنظام الطائفي بشكله المعمول به حاليا. غير أن المؤلّف يجزم، في الآن ذاته، بأن الموقف الايماني يدحض الموقف الطائفي حيث يجب أن يلتقي على هذا كلّ من يأخذ بإيمانه المسيحي على محمل الجدّ. فالطائفة، في فكره، هي الوجه الاجتماعي للكنيسة الفاقد للصفة المسيحية إن استقلّ عن الحياة الكنسية. وما الطائفية سوى انتماء الناس الى هذا الشكل دون أي اعتبار للأساس. هذا ما ينشئ انحرافات و ما يؤدّي الى تشويه للهويّة المسيحية وافراغ الشعائر الدينية من معناها، والأهمّ، إلى تسخير الله لخدمة المصالح والأنانيات. وإن كانت أولى مظاهر الانحراف، التي يشير اليها الكتاب، هي إفراغ المؤسسات الطائفية من بُعدها الخادم الذي وجدت من أجله، فإن أجرأ الشواهد على تسخير الله للمصالح هو استغلال المتنفّذين للشعور الطائفي لتثبيت نفوذ لا يمت الى الله بصلة. فهذا النفوذ لا يبغي الخدمة والتفان بل تعظيم الذات على حساب الغير. وما ينطبق على الفرد يطال أيضا الجماعة بحيث يستحيل بالطائفة مجموعة مصالح تستخدم الله. وفي هذا كفر فعلي بالله استشهد الكاتب لتثبيته بقول المطران جورج خضر: ” هذا هو الكفر عينه، أن نجعل الله وسيلة للوجود، وهو هدف الوجود”.
شاء الكاتب أن يؤكّد أن مقاربة موضوع الطائفية لا تنفصل عن مقاربة الموضوع الأشمل وهو “المسيحية والسياسة”. وقد حملت مقاربته لهذا الموضوع موقفا يتميّز بجرأة طرح. فرأى أن المسيحية، رغم أنها لا ترسم للناس نهجا سياسيا، إلا أن لها، عبر الإنجيل، كلمة في السياسية وذلك بعكس اعتقاد كثيرين. هذه الكلمة توجب أن يكون قصد الله من الخلق – أي تحقيق إنسانية الإنسان – هو منطلق المسيحيين في تقويمهم للأوضاع السياسية والاقتصادية. وهذا القصد قد كُشف لهم، بما لا يقبل الشكّ، بالوحدة بين الله والبشر التي حقٌقها يسوع المسيح بحياته وموته وقيامته والتي أصبحت حقيقة قائمة في صميم التاريخ. ولعلّ هذه الوحدة هي ما يرى بها بندلي دافعاً للمسيحيين من اجل الاعتناء بشؤون الإنسان والأرض. فهل، بالتالي، ما يعيق تحقيق قصد الله أكثر من طائفية تقود الإنسان إلى التناحر والتباغض والجور والتضحية بالإنسان الآخر باسم الله والله عن كلّ هذا غريب؟
